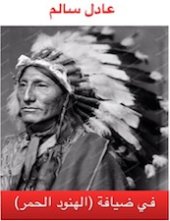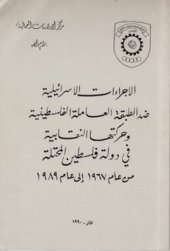- قصص وسرد
- قصائد وأشعار
- بقايا ذاكرة
- مقالات ودراسات
- حوارات
- ظلال الياسمين
- تحت المجهر
- صور للكاتب
- في رحاب القدس
بقلم الدكتور رياض كامل
مقدمة
تدور أحداث رواية «الحنين إلى المستقبل» (2016) للكاتب المغترب عادل سالم في بعض سجون الولايات المتحدة، وبالتحديد في عصر الرئيس أوباما. وتتناول، فيما تتناول، قضية الإنسان العربي الفلسطيني الذي يعيش مغتربا في الولايات المتحدة، كبديل للعيش تحت الاحتلال الإسرائيلي. فيقف في مواجهة واقع مر أليم مما يستدعي إجراء مقارنة أكثر ألما؛ بين سجنين، أحدهما إسرائيلي والآخر أمريكي ـأحلاهما مر).

ما زالت النكبة تؤرق حياة الإنسان الفلسطيني أينما حل، وما زال الكُتّاب يحملون همَّ شعبهم وما لاقاه من تبعات هذا التشرد وهذا الهجيج. فالزمن لم يلكأ جراحه ولم يداوها، فإن كانت النكبة هي رحلة التشرد الأولى، إلا أن سيزيف الفلسطيني ما فتئ يحمل صخرته، يتنقل من قطر لقطر، ومن دولة لأخرى دون أن تبرح ظهره. إذ تتبدّى المفارقة في أحللك صورها، حين يقارن الفلسطيني بين بديلين مهينين صعبين، فيما أن البديل الثالث هو الحياة فوق تراب وطن حر، وفي ظل دولة مستقلة ينعم أهلها بالعيش الحر الكريم، ولا تعاني من الاحتلال وظلمه.
تبدو الرواية، في المواجهة الأولى معها، حكاية رجل فلسطيني يدعى نعيم قطينة يبحث عن حياة أكثر حرية وأكثر ديمقراطية، في دولة يضمن فيها مستقبلا أفضل له ولعائلته، لكنّها في نهاية المطاف هي حكاية شعب تعرّض للنكبة والنكسة والاحتلال، يحاول أن يتابع حياته بحثا عن بديل أفضل مما هو عليه فيصطدم بواقع مر أليم، وتُسد في وجهه منافذ الخلاص ليعود إلى مواجهة قضيته الرئيسية الأكبر. إنها معضلة الإنسان الذي يبحث عن حل لقضيته التي تشغل أروقة المؤسسات الدولية، والتي لم تجد لها حلا حتى اليوم، فيعيش حياة تتسم بالأرق مما يحمله المستقبل. فالتجربة التي مر بها كانت مؤلمة جدا، وما يزال يعاني منها جيلا بعد جيل.
تمهيد
تحدثت الرواية الفلسطينية عن النكبة والنكسة، وعن التغريبة الفلسطينية من زوايا عدة، كما فعل غسان كنفاني، إميل حبيبي، جبرا إبراهيم جبرا، يحيى يخلف، محمد علي طه، محمد نفاع، حسين ياسين، رجاء بكرية وآخرون. منهم من عاد إلى ما قبل منتصف القرن العشرين ليرصد إرهاصات ضياع البلاد والتحضير لقيام دولة إسرائيل، كما فعل الأديب محمد علي طه في رويته "سيرة بني بلوط"، وحسين ياسين في روايته "عليّ، قصة رجل مستقيم" اللتين تناولتا، صراع الفلسطيني مع المحتل الإنجليزي وأبعاد هذا الصراع.
أما أكثرُ ما شغَل الروائيين فهي النكبة والهجيج، كما فعل الروائي يحيى يخلف في رباعيّته (بحيرة وراء الريح)، التي تروي حكاية التشرد الفلسطيني منذ عام النكبة (1948) وما يتبعها، فرأينا الفلسطيني هناك يترك الوطن والأرض والبيت ليبدأ عملية البحث عن مكان يحطّ فيه رحاله، بعد أن تقطعت الأوصال، لتتلوها عملية البحث عن الذات، في ظل ظروف جديدة بعيدا عن الوطن الأم. أما الأديب محمد علي طه في سيرويّة "نوم الغزلان" فإنه يعالج الغربة والشتات والضياع في الداخل الفلسطيني خلال النكبة مباشرة، حتى استقرت العائلة في قرية صغيرة قرب مسقط الرأس. ويطرح الروائي إميل حبيبي في رواية "المتشائل" معضلة الإنسان الفلسطيني وتقطّع أوصاله وضياع هُويّته بعد قيام دولة إسرائيل، من خلال شخصية سعيد أبي النحس المتشائل، وأسلوبه التهكمي الخاص. ويعالج محمد نفاع في روايته "فاطمة" ما تعانيه المرأة الفلسطينية في ظل تدخل الآخر في حياة الفلسطيني منذ الأتراك حتى قيام دولة إسرائيل، وانعكاس ذلك على المجتمع بأكمله من فقر وجوع، وأهمية الحفاظ على الأرض، كجزء هام من الحفاظ على الكرامة.
كما تناول الروائيون الفلسطينيون حياة الفلسطيني بعد التشتت وترك الوطن والبحث عن لقمة العيش في الشتات فكانت رواية "رجال في الشمس" للروائي غسان كنفاني وصرختُه "لماذا لم تدقوا جدران الخزان"، ورواية "عائد إلى حيفا" التي صورت واقع الإنسان الفلسطيني بعد هزيمة حزيران، والعودة المؤلمة إلى الوطن، بعد النكسة مباشرة، والمواجهة المباشرة مع واقع جديد مناقض للمنطق الفلسطيني وأحلامه، في محاولة لطرح البديل.
ورغم مرور سبعة عقود من الزمن إلا أن الروائيين الفلسطينيين ما زالوا يكتبون عن النكبة وتبعاتها؛ فهذه رجاء بكرية تكتب "عين خفشة"، قصة قرية فلسطينية ومأساتها الدائمة وحيثياتها. وهذا عادل سالم، ينشر روايته "الحنين إلى المستقبل"، فما هو جديد هذه الرواية؟ وأي أسلوب اتبعت؟
ملخص الرواية
تتمحور الأحداث حول شاب فلسطيني دخل السجن الإسرائيلي، فقرر بعد الخروج منه أن يسافر إلى الولايات المتحدة حيث "الحرية" و"الديمقراطية"، لكن سلطة الضرائب هناك قامت باعتقاله وسجنه مدة سنتين بتهمة الخيانة والتهرب من دفع الضرائب. وبالرغم من أن السِّجن هنا أشبه ببيت للنقاهة مقارنة مع السجون الإسرائيلية إلا أنه يرى أن تجربة السجون الإسرائيلية، رغم قساوتها، تحمل بعدا إيجابيا: القرب من الأهل والوطن، ومقارعة الاحتلال. أما في الولايات المتحدة فهناك غربة وبُعد عن الأحبة، وهناك خيبة أمل نتيجة ما رآه من عنصرية وتمييز بحق الأجنبيّ، والمسلم والعربي على حد سواء.
ينتظر نعيم قطينة، على أحرَّ من الجمر، يومَ خروجه من السِّجن للعودة إلى أرض الوطن للقاء زوجته وأولاده الذين اضطروا، أثناء دخوله السجن، إلى العودةِ إلى بلدهم القدس، والعيشِ مع الأهل. وبعد أن أنهى مدة الحكم وغادر السِّجن كان عليه، وفق القانون الأمريكي، أن ينتظر فترة أخرى من الزمن حتى يتاح له مغادرة البلاد. وبعد الانتظار يستقلّ الطائرة باتجاه الوطن، لكن السلطات الإسرائيلية تمنعه من دخول البلاد بحجة عدم استحقاقه العيشَ في مدينة القدس، حيث تعيش زوجته وأبناؤه وعائلته، فيعود إلى الولايات المتحدة ليحاول من جديد العودة واللقاء بالأهل والعائلة.
[*السرد:*]
السرد هو الطريقة التي تروى بها الحكاية، وهو يقوم على ثلاثة عناصر تخييلية؛ الراوي، المروي، والمروي له. فإذا كان هذا هو حال السرد الروائي، فأين يقع دور الروائي؟ وما علاقته بالراوي؟
إن الروائي هو خالق الرواية بكل مركباتها وعناصرها، عليه أن يخلُق راويا متخيّلا ينوب عنه في عملية السرد، وبالتالي عليه أن يتّبع طريق الحيادية، وأن يوكل الأمر للراوي، أو للرواة يتناوبون فيما بينهم عملية السرد. والراوي، في عين المنظرين، "كائن من ورق"، مما يعني أنه شخصية روائية يخلقها "شخص" ما، هذا الشخص هو الروائي.
يوظف الكاتب، عادل سالم، ضميرَ المخاطّب في معظم السرد مما يتيح له الخروج من إطار الذات، وخلق فجوة بين أنا وأنت، من ناحية، وبالتالي يُتاح المجال لإبعاد الرواية عن مجال السيرة الذاتية المباشرة. كما يقوم بتوظيف ضمير المتكلم، أحيانا أخرى، للدخول أكثر في عمق النفسية، ويطل علينا ضمير الغائب، بشكل مفاجئ، بين الفينة والأخرى، فيبدو كمن يلاحق الشخصية ويرصد تحركاتها، من زاوية ما، دون أن يدخل في التفاصيل، بل إن دوره يقتصر على تسليط الضوء على بعض التحركات في حياة الشخصية المركزية، كي يكسر روتين الأحداث ويغلق باب رواية السيرة الذاتية.
إن التنقل بين أكثر من راو هو أسلوب فني يحتاج إلى مهارة روائية عالية، ومن شأن هذا التوظيف أن يجعل الرواية مفتوحة على أكثر من رؤية وأكثر من رأي. فهل ذلك يعني أنّ رواية "الحنين إلى المستقبل" رواية ديالوجية؟ وهل تعدد الرواة فيها يفتح المجال لأكثر من وجهة نظر؟
إن هذا التوظيف أتاح المجال لمحاورة الذات، وكأن الشخصية المركزية تخرج من ذاتها كي تحاور ذاتها في حالتها الأخرى، لكنّ السرد والحوار الداخلي لم يطرحا نقاشا متنوعا فيه "حوارية" تبين تلك المواقف المغايرة لدى الشخصية. فقد بدا بشكل واضح أن "أنا" و"أنت" هما واحد بعينه، ولا يحملان وجهتي نظر مغايرتين، وبدا جليا أن هناك اختراقا يقوم به الروائي، بشكل واضح، وكأنه كان مصرّا على التدخل وكشف المستور. وبالتالي فإنّ تبدل الضمائر كان شكليا أكثر منه جوهريا.
تلجأ الرواية اليوم إلى وسائل وتقنيّات حديثة تشبه عملية التصوير السينمائي، حيث تنقل عين الكاميرا الصور، وتجعل المشاهد يرى ويشارك، دون أن يرافق التصويرَ أيُ تعليق، وبالتالي يصبح الروائي والراوي حياديين. هذا ما كنا نأمله، خاصة وأن الروائي قام بهذا التوظيف في مواقع معيّنة من الرواية، فتمكنت الرواية، بفضل هذه التقنية، من محاورة المتلقي، لكنّ هذه العملية كانت تقتصر على بعض المشاهد، ولم تتحول إلى تِقْنيّة مبلورة لتصبح جزءا بارزا من فنيّة الرواية.
[**عنصر التشويق والمفاجأة*]
إن عنصر التشويق من أهم العناصر التي تبنى عليها الحبكة، وذلك يحتاج إلى تقنيّات فنية تفتح باب التساؤلات على مصراعيها: كيف ومتى ولماذا. تتفتح أبواب وتغلق أخرى، ويخلق النص مجال "الفجوات" ليشارك القارئ في عملية التخمين وسد الفجوات، ليصبح جزءا من عملية الإبداع. يحتاج ذلك إلى خلق حالات من الغموض المُتقصَّد، الذي يزيد وتيرة التوتر والإرباك والتساؤل لدى المتلقي، يكتمل هذا الدور من خلال تنوع المشاهد والأماكن والأزمنة، وخلق مفاجآت تبهر القارئ وتشده أكثر لكشف المستور.

ينتقل نعيم قطينة من السجن الأول إلى السجن الثاني، دون أن يحدث أيُ منعطف في سير الأحداث من شأنه أن يُلفت نظرَ القارئ، فكأنّ السِّجنَ الثاني نسخةٌ عن الأول، فاقتصر التغيير على الشخوص واستبدالهم بآخرين. تستمر الأحداث بشكل رتيب، وعلى نفس الوتيرة دون تغيير يذكر. أما التغيير الحقيقي فقد كان بعد الانتقال إلى سجن "لاتونا" (ص193). هذا الانتقال يمثل انعطافا هاما في مجرى الأحداث، إذ يرتفع منسوب التوتر، خاصة وأن الانتقال يأتي نتيجة غبن وظلم لحق بنعيم قطينة، فيما لم يتبق له في السجن سوى ثلاثة أشهر ليخرج بعدها إلى الحرية والنور. يُعاقب نعيم على خطأ لم يرتكبه، ويقرّر السجانون نقلَه إلى "سجن يقع في منطقة جبلية حيث الجبال تحيط بالسجن، والحرارة عالية". (ص193) إنها زنزانة بينما السجنان السابقان أشبه بمتنزه نسبة لهذا الجديد.
هذا المنعطف في الأحداث كان له دور هام في عملية التفاعل بين المرسِل والمُرسَل إليه الذي يتابع ارتفاع منسوب التوتر النفسي لدى الشخصية المركزية، وانتظاره بفارغ الصبر كي يخرج من أزمته النفسية، والتخلص من الظلم الذي يقع عليه، بعد أن كاد ينهي مدة حكمه. ينتقل السرد هنا من الخارج إلى الداخل أكثر، ويتجلى مكنون النفس المؤلم، وتتكشّف أمام القارئ ما يتعرّض له هذا الإنسان من ضيم، لا لسبب سوى أنه ينتسب إلى مجتمع آخر، وإلى قومية أخرى، وفكر آخر.
أما المفاجأة الأخرى، شبه المتوقعة، فقد كانت بعد وصول نعيم قطينة أرض الوطن وانتظار العائلة له، إذ ترفض سلطات المطار في إسرائيل أن يرى العائلة فيعود أدراجه من حيث أتى، بحجة أنّ وجوده في البلاد غير قانوني، فتكتمل صورة الظلم التي يتعرض لها الإنسان الفلسطيني دون باقي شعوب الأرض التي تنعم بالحرية والاستقلال.
[**العنوان*]
تسير الأحداث من الماضي باتجاه الحاضر بما يتلاءم مع عنوان الرواية "الحنين إلى المستقبل". إن الحنين المألوف هو الحنين إلى الماضي، إلى أيام مضت وانقضت. يحنّ نعيم قطينة إلى النور، وإلى العائلة، وإلى الوطن والأولاد. إذن فالعنوان في بعده الزمني يحمل مفارقة بين معناه المباشر وبين ما يتوق إليه السجين؛ إنّه يتوق ويحن إلى الماضي، يوم كان حرا بعيدا عن كل السجون، سواء كانت في الوطن أم في الغربة. أما المستقبل فهو الحلم وهو الأمل الذي يحنّ إليه كل سجين. وحين بدأ الحلم يتحقق وقد ركب نعيم قطينة الطائرة، وبالذات حين حطت عجلاتها في أرض الوطن، أعيد قسرا إلى الغربة، وبقي الحنين وبقي العذاب الذي يعيشه الإنسان الفلسطيني على أرض الواقع.
إنها رواية تتناول الألم النفسي الذي يعيشه الإنسان الفلسطيني حيثما حل وحيثما استقر؛ كان له ماض اقتلع منه عام النكبة، وبات بدون وطن، واحتُلّ القسم الآخر منه عام النكسة (1967). ومن لا وطن حرا له فلن يهدأ له بال، ولن ينام قريرا، طالما هناك احتلال. أما الهجرة إلى أيّ بلد، مهما كان حرا فهو ليس الخلاص الذي يرجوه أي فلسطيني.
إن اختيار هذا العنوان بالذات ساهم في بلورة الرسالة التي تسعى الرواية إلى إيصالها، ليس فقط إلى القارئ المتلقي، بل إلى ما هو أبعد. فالإنسان الفلسطيني مر بما هو مؤلم، رأى الظلم والإجحاف اليومي بحقه وبحق أهله، وبحق أبنائه، في آن معا. خسر الأرض والوطن، وتفرّقت العوائل أيدي سبأ، فلم يتبق له سوى الأمل بمستقبل أفضل، فجاءت التسمية مناقضة لكل ما هو مألوف: "الحنين إلى المستقبل" لا إلى الماضي.
تنتهي الرواية نهاية سوداوية دون إغلاق باب الأمل الكلي، وسواء كان الحنين إلى الماضي، أو إلى المستقبل، فإن كليهما أفضل من الوضع الراهن، وكلاهما أفضل من السّجن ومن الاحتلال ومن الغربة.
اللغة
نعود للتأكيد، كما في دراساتنا السابقة، على أن اللغة هي الأداة التي نعبّر بواسطتها عن أفكارنا، وأنّ شرط الدخول إلى عالم الأدب مرهون باللغة الغنيّة، التي يجيد الكاتب التلاعب بها، بعد أن يتحكّم بها وبأصولها النحويّة والقواعديّة، بحيث تسعفه على خلق عوالم متعددة ومتناقضة ومتحاورة، فتتماوج وتتمازج وتتحاور لتبتعد عن الرتابة والمباشرة، كي تلوّن عالم النص، كما تلون الأزهار الطبيعة بشتى صنوف الورد والشوك والشجر. فالحياة لا تقتصر على صنف واحد، ففيها اجتماع المتناقضات من حزن وفرح وقبح وجمال وفشل ونجاح. والرواية تشتمل، فيما تشتمل، على شخصيات متعددة وأماكن متنوعة، وعلى اللغة أن تكشف هذا التنوع.
بدأت رواية "الحنين إلى المستقبل" بلغة شعرية إيحائية، ثم ما انفكّت أن انكفأت على ذاتها لتنحو طريق التقريرية المباشرة التي تناسب لغة كتابة المذكرات، وكي تنجو الرواية من عقم المباشرة فقد لجأ الروائي، كما ذكرنا أعلاه، إلى توظيف أكثر من ضمير لسرد الأحداث، فانتقل السرد من ضمير الغائب إلى ضمير المخاطب، ومن السرد الداخلي إلى السرد الخارجي، وهي تقنيّة حكيمة وذكيّة لنقل الرواية من خانة المذكرات إلى خانة التخييل، الشرط الأساسي والأهم لكتابة رواية فنيّة.

على اللغة الروائية أن تجمع بين مستويات لغوية عدة، وفق الأماكن والأزمنة التي تدور بها الأحداث، وتجاوبا مع تعدد الشخصيات، واختلاف مواقفها وآرائها ووجهات نظرها. كما أن الرواية الحديثة، اليوم، تتنقّل بين اللغة الشعرية، والتراثية، والمحكية، ولغة الجرائد، واللغة العجائبية والفانتازية وغيرها. وتتنقّل بين الداخل والخارج، وبين شخصيّة وأخرى لتقوم بعمليّة التشخيص، فتلبس كل شخصية لباسها المناسب، وفق هويتها الاجتماعية والفكرية، وتتجول بين الأماكن والفضاءات والشخصيات كجزء من واقع مُتخيَّل.
تقوم كل رواية على السرد والحوار، ولكل منهما دوره، إذ من الأسهل على الروائي أن يكشف عن المزيج الفكري للشخصيات، من خلال الحوار، فتعبّر الشخصية عن رأيها بلغتها الخاصة، لكن الروائي عادل سالم لم يعمل على تنسيق اللغة المحكية لكل متلفّظ في الرواية، إذ هناك فرق بين لهجة كل مغترب وأصوله عن مغترب آخر، وهناك لغة تميز كل فرد عن آخر، حسب انتمائه وهويته وثقافته. كي يتحقق ذلك كان على الروائي، ومن ثمّ على الراوي، أن يتنحى كلاهما جانبا كي تُعبّر الشخصيات عن هوياتها المختلفة والمغايرة.
كان ممكنا أن نرى تعددا لغويا، خاصة وأن الرواية غنية بالشخصيات التي تحمل مواقف متعددة، كما أنّ هذه الشخصيات جاءت من خلفيات اجتماعية وفكرية متنوعة، فقد بدا للقارئ أن الراوي الرئيسي، بدعم من الروائي، قد عمل على خلق هذه الحوارية الضرورية لجعل الرواية تتبدل وتتلون كي لا تسير وفق وتيرة واحدة، لكنّ الرواية، في مجملها، وقفت عند تخوم الحواريّة، ولم تلج إلى الداخل، مما أفقد الأحداث بعض توهجها.
[*خلاصة*]
تبحث الرواية، فيما تبحث، قضية تشرد الفلسطيني، الذي يبحث عن لقمة العيش الحرة الكريمة، حتى ولو كانت عبر البحار، فيتوصل إلى نتيجة مفادها أن الوطن أغلى وأثمن؛ فهو الماضي، والحاضر، والمستقبل.
ترمي الرواية إلى تحميل الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية ما يتعرض له الإنسان الفلسطيني، ليس فقط في الداخل، بل أيضا، في أماكن تشرده. وأما رفض عودة ابن القدس نعيم قطينة إلى بلده الأم، فهو يرمز إلى رفض إسرائيل حق العودة التي لم يتنازل عنها الفلسطيني رغم الغربة.
إن فكرة الرواية أكثر توفيقا من مبناها فنيا، فهي بحث، من جديد، في الوجع الذي يعانيه الفلسطيني نتيجة فقدانه الحريّة في أرضه وفي بلده. تسلط الرواية الضوء على الغبن اللاحق بكل إنسان يعيش في الولايات المتحدة، إذا كان هذا الشخص يختلف في لونه وانتمائه، بما لا يتماشى مع الفكر الأمريكي، فتجلت العنصرية في أقبح صورها. إن هذا الطرح الفكري لا نجد له صدى كافيا في الروايات الفلسطينية، وقد اقتحمه عادل سالم من خلال هذه الرواية. إذ عمد إلى تسليط الضوء على معاناة الإنسان الفلسطيني، الذي يتحمل، في كل مكان وزمان، وزر انتمائه الوطني والديني والقومي، ولذلك فإن ريمون المسيحي، ونعيم المسلم وغيرهما، فهم متهمون بالإرهاب في عين الآخر، وكذلك المسلم العربي والمسلم الأسود فهما متهمان، أيضا، في عين الآخر الأمريكي. هذا الموضوع بحد ذاته كان نقطة مركزية عملت الرواية على إبرازها.
هذا الموضوع الهام عرض في الرواية بأسلوب تقليدي، إذ كان على الروائي أن يعمل على توظيف مستويات لغوية متعددة تُبرز الاختلاف بين الشخصيات المتعددة وخلفياتها الفكرية والقومية، وربما الدينية، لكنّ الرواية لم تسع نحو هذا الهدف. كما أن ذلك يفرض على الروائي أن يوظّف تقنيّات حداثية قادرة على معالجة هذه القضية الهامة، لكن السرد سار في اتجاه التقليد أكثر مما هو في اتجاه التجديد، وبالتالي فإن الروائي كان دائم الحضور في الكثير من المشاهد والمواقف، مما جعل الرواية تبدو، شبه سيرة، ولا أقول شبه سيرة ذاتية، لأنها قد تكون سيرة غيريّة.
د. رياض كامل
تعقيبك على الموضوع
-
ما لم يقله سمير القنطار لرفيق السجن عادل سالم
٦ شباط (فبراير) ٢٠٠٥
-
لم يبقَ في الكونِ إلا الحبُّ و المطَرُ
٢٠ شباط (فبراير) ٢٠٠٦
-
الشمسُ تَحتَ ضِيائِها تَتَشَمَّسُ
٢٦ نيسان (أبريل) ٢٠٠٦
-
"لعيون الكرت الاخضر ".. و"عادل سالم"
٢٧ آب (أغسطس) ٢٠٠٦
-
لعيون الكرت الأخضر
٢٧ أيلول (سبتمبر) ٢٠٠٦
-
العثة... في اميركا أيضاً
١٦ تشرين الأول (أكتوبر) ٢٠٠٦
-
رصد لخسارات المنفى وكشف لزيف الحلم المعوّض
٢٧ كانون الثاني (يناير) ٢٠٠٧
-
لمن سنرفع شكوانا ويسمعنا
٢٠ نيسان (أبريل) ٢٠٠٧
-
ليش ليش يا جارة؟
٢٨ كانون الأول (ديسمبر) ٢٠٠٧
-
نبضٌ مقدسيّ
١٠ كانون الأول (ديسمبر) ٢٠١٠
-
دلالة المكان في أقصوصة العنكبوت لعادل سالم
١٩ تموز (يوليو) ٢٠١١
-
عناق الأصابع في اليوم السابع
٨ كانون الثاني (يناير) ٢٠١٢
-
قصائد الحب في «عناق الأصابع» لعادل سالم
٨ كانون الثاني (يناير) ٢٠١٢
-
عادل سالم في مجموعته القصصية «لعيون الكرت الأخضر»
٢٦ أيار (مايو) ٢٠١٢
-
«عاشق على أسوار القدس» لعادل سالم
٥ أيلول (سبتمبر) ٢٠١٢